صدام الزيدي
على منصّة (زووم) التفاعلية، نظمت مجلة “نصوص من خارج اللغة” فعالية شعرية ونقدية، يوميْ 16- 17 يوليو/ تموز 2020، بمشاركة شعراء ونقاد عرب، خُصّص اليوم الأول للشعر والثاني للنقد (مشكلة التلقي والسردية في قصيدة النثر) وأيضا (راهن قصيدة النثر بالمغرب: من الجيل إلى الحساسية).

نعرض، في مستهلّ هذه التغطية، أهمّ ما ورد في ورقة الناقد والأكاديمي العراقي المقيم بالولايات المتحدة، حاتم الصكر، ومداخلات الشعراء والنقاد وأسئلتهم الموجهة إليه، يتبع ذلك عرض لأهم ما تضمّنته ورقة الشاعر والناقد الأكاديمي المغربي عبد اللطيف الوراري، وثمة أيضا مداخلات وأسئلة وجهت إلى الوراري من قبل شعراء ونقاد حضروا الندوة الإلكترونية (استضافت الندوة إلى جانب المتحدثيْن الرئيسييْن، شعراء ونقادا، في مقدمتهم الناقدة والأكاديمية العراقية وجدان الصائغ، والناقد والأكاديمي العراقي صبري مسلم حمادي (يقيمان في الولايات المتحدة). وأسندت إدارة الندوة إلى الباحث اليمني أحمد الفراصي، الذي استهل الفعالية متسائلا: “هل الناقد هو فعلا ظل النص؟ ما علاقة النص بظله في ظل هذه الغزارة الانتاجية؟ ثم، ما مستوى هذه العلاقة اليوم بين النص وظله (الناقد)؟ وإن كانت العلاقة ضعيفة كما يدعي بعض المبدعين، فمن هو السبب في هذا الضعف؟ هل هو الناقد الذي يقف أمام هذا الكم الهائل من النصوص عاجزا عن الإحاطة بها أم المبدع الذي لم يعد يقبل نقدا ولا يرتضي برأي، في ظل الانفتاح التكنولوجي وتدفق النشر (بسهولة وبحرية) في الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي؟”.
استهل الناقد حاتم الصكر حديثه، بالقول إن النص يتقدم، وفي سيره هذا يجتاز ويتجاوز ويجدد نفسه وتتغير الرؤى والأساليب. وفي هذا الظل الذي يسير إلى جانبه، يجري تنظيم الخطاب وتحليله وتفكيكه، بعيدا عن أحكام القيمة والمعيارية المعروفة، الخ…
كما أن ارتباط النقد بالنص وفقا للصكر (هو ارتباط لاحق بالسابق وليس العكس، لذلك فالنص هو المتفوق).
تفوق النص!
يشير الدكتور الصكر إلى أن عملية النقد هي عملية تحليل في المقام الأول “ترويض النص” (كما أفهمها وكما أسميتها في واحد من كتبي المبكرة: وهو في الأصل أطروحة الماجستير وبعض الزملاء تابعوها وكانت حتى مقررة في بعض الجامعات العربية للدراسات العليا، بينت فيها ما خلاصته أن الناقد يقوم بممارسة نقدية على نص يعلم أنه متفوق عليه، بل نصًّا يملك قوة فائقة تحتاج إلى ترويض: “فالنص متفوّق دائما على الناقد. النصّ يمتلك مقوماته وعناصره، ونحن نأتي لنقوم بقراءته وتركيبه مجددا. لذلك فهو قوة فائقة نحاول أن نروّضها كما يفعل مروّض الأسود، هو يعلم جيدا أن الأسد أقوى منه لكن مطلوب منه أن يغفل هذه الحقيقة وهو يقوم بترويضه واكتشاف ما فيه من غير ما هو موجود في طبيعته. وأنا مدين بهذه الفكرة للناقد البريطاني تيري ايغلتون. وهو من النقاد الماركسيين الجماليين، وفكرته هذه يطرحها في أكثر من كتاب: أنه يجب أن يعلم الناقد بأن النص متفوق عليه”.
يتابع الصكر: “نحن الآن نحتك بنصوص المتنبي مثلاً وأدونيس والسياب، إلخ… لكن نعلم أن النقد يعطينا من الأسلحة (إذا صح التعبير) بتعبير جمالية التلقي، أو الذخيرة، هم يستعملون كلمة “ذخيرة”. ياوس وزملاؤه قالوا إن النص فيه قوة كبيرة لكن النقد والقراءة أهم. ويستعملون كلمة القراءة وأنا أميل إلى القراءة وشخصيا لا أحبذ استخدام كلمة ناقد، هي كتابة على كتابة النص). يقولون إن النص يطلق أسلحته وذخيرته للمتقبل يستعملون كلمة عسكرية. هم فاهمون جيدا ثقافة القراءة وبنوا عليها مصطلحاتهم ومفاهيمهم وهذا الأهم”.
ويشدد الناقد الصكر على أن الذخيرة التي يطلقها النص تتطلب رد فعل من الناقد كي يفكك ويحلل ويستوعب ويكشف المسكوت عنه أحيانا في بعض النصوص: “عليه أن يستنفر ذخيرة مقابلة للرد على هذه الذخيرة واحتوائها.. احتواؤها ليس من باب الاحتلال ولا الإلغاء ولا الإقصاء، إنما من باب إعطاء قيمة أكبر للنص”.
ويذكِّر الصكر بما كتبه ذات مرة، أن “بعض الكتابات النقدية تبدو أكثر حنانا ورفقا واهتماما بالنصوص حتى من أصحابها”، مستشهدا بموقف: “حصلت معنا مرة، عندما قمنا بتحليل قصيدة لشاعر معروف، ل بي، قائلاً إنه وبكى وقال تأثراً مما كشف عنه المقال: معقول هذا الكلام أنا قلته كله وأنا لا أدري هذه البنية التحتية التي في النصوص”. وجاء استذكار الصكر لهذا الموقف في سياق ما قال عنه (تبسيطا متعمدا للفكرة حتى لا أبتعد كثيرا، وأصل من بعد إلى الاهتمام بالبنى النصية التي غابت للأسف في الفكر النقدي السابق عن جيلنا، ومنها “العتبات النصية”. مؤكدا بالقول: “شخصيا، أنا من المؤمنين بأن النص له عتبات. العتبة في الفكر الرافديني القديم، تعتبر مقدسة. محرم أن يدوس عليها الإنسان. ولليوم: العراقي لا يدوس على العتبة، يعتبر العتبة شيئاً مقدساً، وملحمة جلجامش تذكر أنه: لا تقف عند العتبات وادخل الأبواب إلخ… العتبات مهمة ليس فقط لجمالياتها، كنا منذ فترة مفتونين بعناوين واستهلالات وإهداءات، كأن يرسم أحد الأدباء صورته ثم يكتب: هذا الرجل سيموت يوم… وترك فراغا، فللقارئ أن يملأ هذا الفراغ.
وأضاف: “هذه عتبات نعم، لكن أنا أتكلم عن موجهات قراءة. عندما يكون العنوان مدروساً جيدا، يؤدي وظيفة جمالية، أو إيحائية، أو رمزية إلخ ذلك.. أو حتى المضمونية، أحيانا يحب الشاعر أو الكاتب أن يلخص فكرته، لكن يجب أن يُدرس أولا وأن يُولى الاهتمام، ويوجه قراءة القارئ. حتى التجنيس والأغلفة، كثير من الشعراء يكتب على واحد من أعماله: ديوان. الثاني يكتب عليه: مجموعة شعرية. الثالث يكتب عليه: قصائد. وأعتقد أن هذه بلبلة، اصطلاحية سببها غياب المفهوم. نحن نُتّهم دائما (أي الذين يكتبون عن الشعر بالذات وكل الكتابة النقدية) أننا نعيش في فوضى، أو ما سمّيناه “برج بابل” نقدي واصطلاحي، لكن في الواقع، الشعراء يساهمون أيضا في هذه البلبلة، وهم بناة هذا البرج أيضا من جهة أخرى. كيف؟ : الشاعر أيضا يجب أن يفهم ماذا يفعل؟ المجموعة الشعرية: جمع قصائد غير موحدة في الرؤية. لكن، هناك ديوان.. عبد الفتاح بن حمودة، مثلا، واحد من دواوينه: قصائد قصيرة (هايكو، وهي ليست في حاجة إلى عنونة ولا أرقام، لا بدّ أن يكون هذا مدروساً. كما هو الحال في قصائد صلاح فايق الأخيرة كلّها. وبعض الأحيان القصائد تنضمّ إلى مجاميع داخل الديوان نفسه أو المجموعة الشعرية، داخلها هناك تقسيم. هذا كمثال فقط يغيب، مثل الاهتمام بالاستهلالات، بالإهداءات، بالخواتم، النهايات أيضا، وغير ذلك”.
وتابع الصكر: إن المنظومة النصية متشابكة، مشبها إياها بعمل المركبة حيث كل جزء منها يكمل الآخر ويؤدي وظيفة ما كي تنطلق السيارة: “المنظومة النصية في اعتقادي، منظومة متشابكة، يحلو لي غالبا أن أشبهها بعمل السيارة. فعندما تفتح مفتاح السيارة تسمع صوت المحرك وتشتغل لكن في الواقع منظومة كاملة اشتغلت في تلك اللحظة: الزيت والماء والهواء والفلترات التي توصِّل هذا كله، بمعنى: الذي وصلك صوت واشتغل هو في الحقيقة نتيجة منظومة كاملة، منها في عمل القصيدة عناصر الإيقاع ومنها التركيب الكلامي ومنها الصور والبلاغة وغيرها من المستويات التي اتفق النقاد عليها منذ زمن، مستويات، حتى المستوى الخطي دخل فيها، الهيئة الكتابية كيف تكتب؟ ثمة شاعر هو محمود البريكان وهو حتى عربيا معروف، لما كنا في المجلة نشتغل، يبعث لنا القصيدة ويصرّ أن يرى البروفة الأولى لها مطبوعةً، لأنه يضع جملا شعرية أكثر من واحدة في سطر شعري واحد ويتعمد ذلك. هذه، إذا غابت الهيئة الخطية عن وعي الشاعر، وأنا هنا، لا أريد أن أعمل سجالا بين الشعراء والنقاد، لكن في الواقع، أريد أن أخفّف من تهمة أن النقد (النقد الشعري بالذات) يعيش فوضى اصطلاحية؟ نعم، هناك مصطلحات مختلف عليها وليست مجانية، فعندما نقول “شعر حر” للآن، أنا لا أستخدمها لما كتبته نازك الملائكة، مثلا، أستخدمها لما كتبه يوسف الخال وتوفيق صايغ وجبرا، الذين كتبوا بجانب قصيدة النثر. قصيدة النثر شيء آخر”.
ويسترسل الصكر متحدثا عن المصطلحات كمفاتيح: “المصطلحات مهمة، هي المفاتيح للتواصل، ثم يتم بيان مفهومك إذا كان مصطلحك واضحا”.
مشكلة التلقّي..
وفي تشخيصه لمشكلات قصيدة النثر العربية الراهنة، يجد الصكر أن
“الوصول إلى قصيدة النثر يضعنا في قلب مشكلة نصية: كيف هي الخبرة عند القارئ؟”. وقال الصكر إن “مشكلة قصيدة النثر في أغلبها مشكلة تلقٍّ” ويجد أيضا أن “استضافة السرد في القصيدة صار موضع التباس”، منوّها بأنه “على الشاعر أن يقوم بما يشبه الفلترة حتى يخفف من عبء السرد في القصيدة، كي لا تصبح قصة قصيرة أو أقصوصة قصيرة جدا”، مشيرا إلى أن الشعر يفرز قوانينه وأعرافه ومزاياه من خلال نصوص. تتراكم هذه النصوص. نتعلمها في المدرسة، وتتردد في البيت، حين يستشهدون ببيت من هنا وحكمة من هناك. بيت مكتمل يعطي معنىً. ثم نأتي إلى مرحلة أخف وهي “التجديد”، نقرأ قصائد حرة وفيها شيء من المرونة النغمية، لكن أن يأتي إلينا شعر أو قصيدة دون إيقاع وزني معروف كما هو متوارث، تبدأ خبرتنا السابقة المتراكمة والذخيرة النصية التي عند القارئ ترفض هذا كأيّ جسم غريب يدخل إلى الجسم البشري، يرفضها ويتكلس ضدّها حتى يطردها. ويقصيها من النوع.. أعتقد أن هذه مهمّة مشتركة بين الشعراء والنقاد، لأن استضافة السّرد في القصيدة صار موضع التباس. أرجو أن يُسمع من الشعراء كيف يفهمونه؟ لأن السرد يأتي معبّأً بكل تقاليد النثر وكل اشتراطاته: التسميات والشخصيات والتّزمين الزماني والتحيين المكاني… بالتالي، على الشاعر أن يخفف من عبء السرد في القصيدة، كي لا تصبح القصيدة قصة قصيرة أو أقصوصة قصيرة جدا كما يقولون.
وتابع: هنا المتكلم المهيمن على السرد في الغالب الآن صار “الأنا”، لو لاحظتم، ثمة من يكتب بعلو صوت الأنا. هذه في حاجة إلى مراجعة وإلى رؤية من هو السارد في قصيدة النثر، وبالتالي كم من الشخصيات تتحمل، كم من الأحداث والوقائع تتحمل والأزمنة والأمكنة حتى لا تصبح نثرا؟ المرحوم سركون بولص تكلم بالمناسبة في اليمن على هامش مؤتمر الشعر العربي الألماني، ودار حديث عن السرد، وصرّح أمام زملاء له أنه متوجس قليلا من هذه المسألة وكيف تسهم في الانتقال بالشعر من الثقل الوزني والبلاغي والصوري، وهذه السيولة اللغوية والعاطفية، إلى القصيدة، هذا يتطلب أعباء كبيرة.
وتمنى الناقد الصكر، أن يعيد الشعراء النظر في مسألة السرد في القصيدة، ”فهو عبء ثقيل في قصيدة النثر حتى لا تتحول إلى سردية خالصة. ولا نعني موضوع الضعف والادعاء: كثير مما ينسب أو يود الانتساب إلى قصيدة النثر يجب ألا يكون حجةً عليها، لأن قصيدة النثر صار خطابها واضحاً وتراكمت نماذج كثيرة وصارت فيها أجيال. أيضا بقي موضوع أودّ أن أشير إليه، أنا أسميه “آباء النص” وآباء النص هم الذين يتركون بصماتٍ وآثاراً ويذهبون. النصوص تتشرب وأنا أستخدم تسمية التشرب الروحي والإيقاعي وحتى اللغوي أحيانا وزاوية النظر، ولكن هذا يتطلب عناية كي لا تكون في التناصّ ذريعة لكل من يأخذ نصا ويعتاش عليه. نعم، التناصّ هو حياة قصيدة سابقة في قصيدة لاحقة، حياة فكرة سابقة في فكرة لاحقة، لكن آباء النص هؤلاء يجب ألا يظهروا، مثل الطعام، نحن نأكل كثيرا.. هذا الصباح أكلنا من كل شيء، لكن عند المحلل الباثولوجي الذي يحلل دمنا، لا يرى عينات طرية محددة، لا، يرى حُجيرات دموية ممتصة في الجسم، أعتقد أن هذا الامتصاص الآن ضعيف في بعض النصوص في قصيدة النثر، كان بالإمكان أن يكون أفضل من ذلك بموازنة التناصّ وفهم آليته واشتغاله”.
مداخلات وآراء نقدية..
استهلت الناقدة والأكاديمية العراقية وجدان الصائغ، أولى المداخلات منوّهة في البدء بأن الدكتور حاتم الصكر كعادته، هو يكتب نصا نقديا، ولكن يصل إلى مستوى الإبداع “لذلك أنا شخصيا أظلم نصوص الدكتور حاتم لو قلت إنها (ظل الإبداع)، هي ابداع في حد ذاتها”.
وقالت الصائغ إن ورقة الدكتور الصكر تضمنت نقاطا تؤرقها هي شخصيا، بحكم اشتغالها النقدي. وهنا سألت الصائغ الدكتور الصكر بقولها: ذكرت فكرة “الذخيرة”، تقول هناك ذخيرة نقدية وهناك ذخيرة إبداعية، وذكرت أنه هناك المستقبِل وهناك المرسِل المستقبِل، وذكرت أن هذا يذكّر بالفندقة والضيافة، وأنا أعجبتني هذه الفكرة، ولكن وجدت أنه الذخيرة، ذخيرة الناقد وذخيرة النص: الذخيرة هي المؤونة أم الذخيرة السلاح؟”. وأجاب الصكر منوّها بأهمية سؤال كهذا يتضمن وخزا للخطاب النقدي وأوضح بقوله: الذخيرة استخدمت بمدرسة القراءة والتلقي، وهم استأنسوا بجماليات ياوس وأيزر، يستعملون “ذخيرة” بالمعنى الحربي. أنه: النص مدجّج بذخيرة فنية وهذه الذّخيرة تتطلّب من الناقد (أو القارئ عموما) أن يستنفر ذخيرته هو أيضاً، حتى يحتوي هذا النص. هذا إعلاء للنص وليس تهمة له. النص فيه قوة، عليك وأنت تقرأ وأنت تريد أن تحيط بالبنية الفوقية إلى ما هو غاطس تحت ألفاظه ودلالات الخطاب. الدلالة لا تأتي واضحة مسماةً في النص. تعرفين ذلك دكتورة وجدان، لأنك تستعملين التحليل النصي وتعرفين. إخراج الدلالة وتوظيفها لإضاءة المناطق المعتمة في النص، أو ما يقولون عنه: استكمال الثغرات كما يسمّونها. هناك ثغرات جمالية وبنيوية داخل النصّ تكملها الكتابة، النصّ يترك فراغاً وعلى المحلل أن يكمل. إذن فهي ذخيرة تتطلب منك أن تستخدم ذخيرة أخرى، أما قضية الاستقبال فهي شيء من فكاهيات وشعبويات النقد أنه انتقدوا مدرسة التلقي، قبل أن يطورها الجماليون الذين جاؤوا بعد رواد هذه المدرسة، فالاستقبال هو الترحيب، لكن في الحقيقة هم يريدون أن يؤكدوا مهمة المتلقي في الحوار مع النص.
وتابعت الناقدة وجدان الصائغ، مداخلتها وأسئلتها: كنت أتمنى أنه يكون ذخيرة بمعنى المؤونة، يعني يستخدم المبدع ذخيرته، بمعنى مُؤَنه، كامل ثقافته التراكمية، لكن في إطار الذخيرة وهي المعركة، تقودني إلى شيء ذكرتَه أيضا وأنا لا أتفق معك، فاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، يعني أنت تقول إنه “ذخيرة المبدع في مواجهة ذخيرة الناقد”، أنا لا أدخل في هذه الذخائر وأود أن لا أكون جزءا من هذه المعركة، لأن هذا يقودني إلى شيء آخر، يقودني إلى ترويض النص، أنا أجد أن النصّ هو الذي يروّض الناقد، يعني أنا لا أروّض النصّ، ولذلك أنا أخلع عن يدي، لحظة الكتابة النقدية، قلم المعلم وسوط السائس، أنا لا يحق لي أن أقف وأعامل النص بوصفه حصانا جموحا، بالعكس، أنا أصلا، أنا كحصان جموح ناقدة وأنظر إلى النص وهو الذي يروضني، ويعلمني كيف أتعامل معه، يعني هو عملية ترويض النقد في حضرة النص الابداعي”.
وأضاف الدكتور الصكر مستدركا: “عطفا على كلمة ذخيرة، يبدو أنني ما أجبت بشكل كافٍ، هم يستعلمونها مثلما نقول اليوم “هناك اشتباك نقدي”، هذا لا يعني وجود مقاتلين وقتلى، لكن نحن العراقيين ذاكرتنا ممتلئة بالحروب (د. وجدان: حربية)، لكن حقيقةً هم يقصدون بالنص ما معناه أنه لا تستهن بالنصوص، النصوص تحمل الكثير من أسلحتها الخاصة وعليك أن تحيط بها، الترويض هو لأجل إضاءتها وليس لإلغائها وإقصائها، أنتِ الآن توهمتِ وقلت لا أقبل بمسمى ذخيرة (الصكر مخاطبا الصائغ). ترويض بمعنى تهدئة، كبح جماح. المستويات المشتغلة في النصّ قويّة فيها إيقاع ولغة ولذلك نحن ضدّ الإنشاد، لماذا؟ الإنشاد إلقاء النصّ بطريقة مسرحية (منذ زمن طه حسين قال: مرة جئنا نستمع وصفّقنا لأحمد شوقي ثم عدنا إلى البيت لم يبق شيء، راحت مع التصفيق).
واليوم قصيدة النثر (جميع الزملاء والزميلات الذين أمامي وحتى من روادها الأوائل)، ليست قصيدة إلقاء، والاشتباك معها وترويضها يتمّ بفتح مداخلها”.
توظيف السرد في القصيدة
وفي سؤال آخر لوجدان الصائغ، سألت الصكر: “عادة نقول عن التناصّ إنه شيء من “التلاص”، يعني هناك تهمة، تهمة ساذجة صح؟ لكن ما ذكرتَه أنت دكتور، أن التناص هو حياة قصيدة سابقة في حياة قصيدة معاصرة، هذا من أروع ما سمعت. وبالنسبة إلى إشكالية، تقول إشكالية قصيدة النثر إنها تكون شعرية مخفّفة في إطار سرديّ (بالعراقي الفصيح: ثخينة) يعني سميكة، سردية قوية، فلذلك يضيع السارد، فما هو الحل، يعني كيف لي عندما أدخل في رحاب الرواية وحينما يتكلم، أنا أعرف الأنا السارد، ولكن في إطار القصيدة حينما تكون دفقة شعورية تعكس وجه الشاعر لحظة الكتابة، فكيف تحدد مسار النصوص؟”.
الصكر مجيبا: “أنا أحتكم إلى النصوص. النصوص نفسها تنتج هذه الانزياحات والخروج على المعادلة النثرية. النثر يقول الشيء ببرود وهذا نعرفه كلنا.. إدخال النثر في الشّعر لإعطائه هيئة جديدة للمفهوم، مثلا، هناك ديوان عنوانه “العاطل عن الوردة”، لكن فعلا قدم لي نموذجاً من الانزياح الجيد، إنه “العاطل عن” ثم “الوردة”، هذا أعتقد توظيف السرد في القصيدة، يجب أن يخضع لمثل ذلك، وإلا فنستلم نصوصاً هي أقرب للقصة، رغم أن النقاد الفرنسيين يؤرخون لقصيدة النثر في كلّ كتبهم الأخيرة والجديدة، يقولون إن هناك قصصا قرئت وهي في الحقيقة قصائد نثر، هم يتكلمون عن مقاطع من هذه القصص على أنها قصائد نثر، لكن نحن لا أعتقد أن نثرنا يسمح بمثل هذا. النثر يأتي محمّلا بحمولة كبيرة من المنطق والعقل، وأعتقد أن القصيدة في حاجة إلى أن ترجع إلى مفهوم الترويض: تهدئة هذا النثر، إنزال المخيلة فيه حتى تلتقط منه ما يمكن ويأتي في سياق القصيدة، من منطقة النثر إلى الشعر، لا بدّ أن تكون هناك تصفية لكل ما يحفّ بالنثر من عاديات الحياة اليومية ونثرها)).
من جهته، قال الناقد صبري مسلم إنه: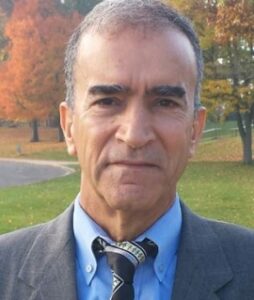
من خلال استعراض الشّعر العربي كلّه، بدءا بالقصيدة الجاهلية، من المعلقات إلى حدّ هذا الوقت، لا ينجو النصّ الشعريّ من عنصر سرديّ ما، حتى معلقة امرئ القيس، مثلا، عندما يقول: وليلٍ كموج البحر… لا يمكن أن تتخيل امرئ القيس إلا في ظرف زماني معيّن وفي ظرف مكاني معين، وهو شخصية أيضا فيها عنصر سرديّ شئنا أم أبينا، حتى المديح والرثاء والهجاء، كلّ هذه هي عبارة عن رسم شخصية، سواء رسم لشخصية شريرة بالهجاء مثلا، أو رسم لشخصيّة قد غادرت هذه الحياة في الرثاء، أو في المديح لشخصية خيّرة. وخصوصا في قصيدة النثر الآن هذا العصر، أكاد لا أرى قصيدة لم يكن فيها عنصر سردي، والعناصر السردية كثيرة، هناك حدث، زمان، مكان، رسم شخصية، حوار إلخ… لا تكاد تخلو قصيدة من ذلك، فلا مناص من هذا التوافق السرد-الشعري، وإن كانت مثلما ذكر الدكتور حاتم الصكر (الحديث هنا للناقد مسلم)، آليات الشعر غير آليات السرد، لكن هذا الاشتباك السردي-الشعري، أنا أحب أن أسمع رأي الدكتور حاتم فيه؟ ليجيب الصكر بدوره مخاطبا صبري مسلم: ”دكتور، أنت من المهتمين بتقصي مفردات التراث الشعبي في القصيدة القديمة والحديثة، لكن أنت تتحدث عن القصة بالضبط، هذا المصطلح استعمله دارسو التراث الشعري العربي: القصة في الشعر، كان يعمد بعض الشعراء إلى نظم بعض القصص وإذا أردت أن تحيل إلى نماذج محددة في الشعر الجاهلي خاصة وقليل من الشعر الإسلامي، لكن الآن نحن نتكلم عن شيء مختلف تماما، وأجد أن الدكتور عبد اللطيف الوراري وضع يده على نقطة مهمّة: تخفيف حدّة هذه الاندفاعة الغنائية والموسيقية في القصيدة، تهدئتها لصالح العناصر الشعرية الأخرى، لغة أكثر هدوءا، صور ليس فيها هذه السيولة والميوعة العاطفية المعروفة، وهذا تقرؤونه حتى في زملائنا الذين معنا في الندوة، دواوينهم التي طلعت، سواء بن حمودة، أنا قرأت له مؤخرا، عبود الجابري، أسامة حداد أيضا قرأت له مؤخراً ولآخرين أيضا. النثر هنا يصير فيه جانب تعضيدي للشعرية الموجودة في القصيدة، يعني الغلط هو أن يأتي من مركز النثر إلى قطعة نثرية وكأنه غير معرّض إلى نوع من التصفية. القصة هناك تجيء بكامل العناصر، هنا عندنا مركز هو الشعر، وهذه كلّها استضافات لتقوية الخطاب”.
تسونامي سردي…
خاتمة الأسئلة الموجهة إلى الناقد الصكر، جاءت من الشّاعرة المغربية إيمان الخطابي التي سألت: هل يعتقد الدكتور حاتم الصكر أن هيمنة عنصر السرد على قصيدة النثر يمكن أن تكون مجرد تقليعة ستأخذ فترة زمنية ثم سيبحث الشعراء عن أساليب وصيغ أخرى من باب التجديد الشعري؟ لتأتي إجابة الصكر: “الواقع، بصدد الهيمنة السردية على المنظور القريب، أنا بصفتي متابعا للشعر، أقول لك بالعكس، الآن تركزت هذه السردية رغم أنها تفتّتت. ودليل على ذلك هو شيوع القصيدة القصيرة جدا أو قصيدة الومضة أو الهايكو (الذي عليه خلاف في التسمية أو الهدف منه).
هذه الأشكال هي تناسلت من السرد في قصيدة النثر، شجّعها ذلك لكنها استقلّت بأشكال وأعتقد (كي نكون دقيقين) هي أنواع شعرية، ربما ستستقرّ أكثر. وهذا يعني أننا أمام تسونامي سردي طويل على ما يبدو، إلى أن يستقر، لكن هذا لا يمنع في المقابل من وجود المعالجات الأخرى التي تخفف (مثلما سماه الدكتور الوراري) من ثقل هذا النثر، تخفيف باللغة، تخفيف بالحدث نفسه. دائما الإحالة الأكثر للشعر، لا أدع العنصر السردي حيّا مثلما هو، أو كأمثولة الطعام التي ذكرتها في البداية، يعني يظهر في القصيدة، أنه هذه قصة وهذا شخصية، التّسميات والشّخصيات موجودة حتى في الشعر الحر، بقصائد الرواد والذين بعدهم والستّينيين. لكن السرد الآن أخذ هيمنة كبيرة، صار موجهاً قويا في قصيدة النثر والعمود الفقري الذي تنبني عليه لحمة القصيدة. أعتقد أن هذا سيطول زمنياً بقراءتي المتواضعة وبمتابعتي.
الخطابي (مستأنفة التساؤل): “ربما بسبب تفوق الرواية مثلا أو اكتساح الرواية؟”.
الصكر (مجيبا/ مستأنفا حديثه): “ممكن.. نعم ممكن، نحن اختلفنا مع د. جابر عصفور حين قال: هذا زمن الرواية. الأنواع لا تنسخ بعضها كناسخ ومنسوخ، الشعر لا يمكن أن يقدم (فيدباك)، يعني ردّ فعل مباشر مثلما يعمل الروائي الذي يقدر على أن يأخذ مساحته في تقييم الحدث وتمثله، بذلك يجد الناس أنفسهم في رواية تسجل لنا ما حدث أو تعلق عليه، بينما الشعر يقطّره تقطيرا ويصفّيه من كل الحدث، وفي المقابل أعتقد أن الزمن ليس زمن رواية مثلا، لكن عليّ أن أعترف، احتكاما إلى جوائز نوبل مثلا والجوائز العربية مثل كتارا والبوكر.. هناك جوائز عديدة الآن وتشجيعها للرواية. والأكثر حماسة هو ما سمّيته “موسم الهجرة إلى الرواية من قبل الشعراء”، هذه تخيفني كمهتمّ بالشعر، سيادة الرواية قراءةً وفي المحافل الرسمية والتشجيع والكتابة، انتشرت الكتابة العربية الروائية كثيرا وتنوعت ودخلت مناطق جديدة وطليعيّة وهذا حديث آخر، لكن يقلقني انتقال الشعراء السريع إلى كتابة الرواية. وصار هنالك جوّ روائي، فيه نوع من الموضة، سيطر على كل الناس.
بالنسبة إلى السرد في القصيدة، يبقى الشاعر المميز الذي يخذل أفق القارئ ويجعله يحس أن هذه القصيدة ليست مثل ما يتوقع. أعتقد أن التركيز على شعرية القصيدة، يخفف من السرد وتظهر العناصر الإيقاعية التي تتقدم إلى الأمام أكثر من المستوى السردي بالقصيدة”.
قصيدة النثر المغربية..
نعرض تاليًا، أهمّ ما تضمنته ورقة الشاعر والناقد الأكاديمي المغربي عبد اللطيف الوراري، التي انتظمت في المحاور التالية: قصيدة النثر بالمغرب: تاريخ ونماذج؛ الحساسية الجديدة بديلا عن مفهوم الجيل؛ السمات الجمالية في متون الشعر العربي الجديد.
ثم نشير إلى أهم المداخلات والنقاشات تعقيبا على ما ذهب إليه الدكتور الوراري.
في مستهل ورقته، قال الناقد عبد اللطيف الوراري إنه يعتبر حاتم الصكر واحدا من أهمّ قامات نقد الشعر العربي، مشيرا إلى أنه تتلمذ على كتبه النقدية، لا سيما ما يتعلق بنقد قصيدة النثر والتنظير لها. وفي هذا السياق، قال الوراري: “أحيي في الدكتور حاتم الصكر هذه المقاومة، وكيف ظلّ إلى الآن محتكّا بنقد الشعر، في حين أن كثيرا من النقاد تخلوا عن الشعر وتوجهوا إلى نُقود أخرى. أحييه.. في الحقيقة تعلمت منه وما زلت أتعلم من كتبه وأخصّ بالذكر (مرايا نرسيس) التي استفدت منها أيما استفادة في أطروحتي للدكتوراه”.
وبشأن عنوان الفعالية، اعتبر الوراري أن “الظل” فيه شيء من الغموض، بينما أيّد رأي الصكر في أن النص هو “ذخيرة”، وأضاف بقوله: “النص هو (النبع) الذي يعطي للناقد المقارب إمكانات مهمّة لإضاءته وترويضه بكل بُناه الداخلية النحوية والأسلوبية والإيقاعية وغير ذلك”.
ويرى الوراري أنه ليست هناك علاقة خصام بين الناقد وبين النص: “بالعكس هي علاقة جدلية، علاقة ترابط بين الشاعر والناقد. هي علاقة مستمرّة منذ القديم”.
بين ضفّتين..
ومتفاعلا مع قضية الشعر العربي، قال الوراري: “أعود إلى قضية الشعر العربي، وهنا أحاول أن أضيف نقطة مهمّة جدا، هي العلاقة بين الضفتين. عندما أتحدث عن الشّعر العربي دائما ما تحضر ضفّتان: ضفة مضاءة، وضفة معتمة. الضفة المضاءة هي للشعر العراقي والشّعر السّوري والشّعر المصري والشّعر الفلسطيني إلخ… لأسباب كثيرة؛ ثقافيّة وسياسيّة وتاريخيّة. والضفّة الأخرى هي ضفّة معتمة مسكوت عنها ومنسيّة ومكبوتة مع أنها قارّة قائمة بذاتها؛ أنا أقصد الشّعر المغربي والشّعر التونسي والجزائري والليبي والموريتاني..”..
واعتبر عبد اللطيف الوراري أنه تمّ تقويض المركزية وتمّ إعادة الاعتبار للأطراف: الشعر المغاربي، الشعر اليمني والشعر السوداني، مؤكدًا أن “الأطراف” باتت مهمّة الآن وتختزن نصوصا وأسماء مهمّة في الشعر العربي وعلينا نقادًا ومهتمّين ودارسين أن نتفاعل معها، وهي لا تقلّ أهمية عن الشّعر الذي يكتب في مصر وفي العراق وغيرهما.
ويجيب الوراري عن تساؤلات ملحّة: لماذا نرى اليوم غياب الاهتمام بنقد الشعر، في المقابل هناك تفجُّر النصوص والمتون الشعرية الكثيرة التي تضخّها المطابع ومواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك.. مستدركا بقوله: “يظلّ الناقد اليومَ حائرا وسط هذه القارة العائمة من النصوص، وحتى إذا أردنا أن ندلي برأينا في ما يخصّ قيمة هذه النّصوص، يصعب علينا أن نمسك بها، ولهذا فالكثير منه عبارة عن أحكام مسبقة، عبارة عن كليشيهات وعبارات مسكوكة (إطلاق قصيدة النثر على عواهنا، هناك أزمة وتراجع، ارتداد شعراء، هناك آباء وهناك أبناء..). والحقيقة أنّ هذا كلّه يسهم في إغناء النقاش وتجسير العلاقة بين الشّعر العربي بكل أشكاله بما فيه قصيدة التفعيلة والشّعر العمودي وشعر الهايكو والشّذرة، إلخ. الناقد الذي لا يستطيع اليوم تحت رحمة هذه النصوص المتفجّرة أن يُلمّ وأن يمسك بعناصرها الجمالية.
وتحدث عن قصيدة النثر، مبيّنا أنّ الأمر لا يعود إلى إطار المسائل الخلافية: قضية المصطلح، قضية التاريخ فحسب، بل إلى العناصر الوافدة من الخارج كيف تمّ توجيهها في بناء قصيدة النثر العربية وتكريسها، ولاسيما مع مجلة شعر فصاعدا. لقد أثير حول هذه المسائل الكثير من الجدل، لكن أحب أن أتوقف عند قضية مهمّة وهي قضية قصيدة النثر في المغرب.
قلّ أن نسمع اليومَ عن ناقد من المشرق يتحدث عن قصيدة النثر بالمغرب، أو أن يذكر أسماء مؤسسة داخل هذه القصيدة. وحتى إنْ ذُكِر اسم ما، فإن هذا فيه مظلمة لأسماء أخرى ساهمت في تطوير هذه القصيدة.
محمد الصبّاغ و“شجرة النار”..
وتابع بالقول: “في نظري، عندما نؤرخ أو نحاول أن نؤرخ لقصيدة النثر العربية، يجب أن نضع في الاعتبار مجموع الخصوصيات الثقافية والجمالية لكلّ بلد؛ فالمغرب مختلف تماما عمّا يقع في العراق أو في مصر أو في سوريا، لا سياسيا أو تاريخيا، ولا من حيث التقارب الجغرافي مع الضفة الشمالية، أقصد: الشعر الإسباني والشعر الفرنسي. فهذه الموجهات الاعتبارية تعطينا إمكانات أخرى لقراءة وجه آخر ومسكوت عنه بالنسبة إلى قصيدة النثر العربية.
بالنسبة إلى قصيدة النثر في المغرب، نحن نستحضر نموذجين كبيرين:
النموذج الأول يقترن بالشاعر محمد الصباغ، وأتمنى أن يكون هذا الاسم قد سُمِع من قبل الكثيرين. محمد الصباغ هذا الشاعر ابن مدينة تطوان الذي عاش بين 1930 و2013 كان من أهمّ مؤسّسي قصيدة النثر المغربية، إن لم أقل العربية. وهذا الشاعر استفاد من الحركة الشعرية الإسبانية، وأقصد هنا جيل 27 (ألكسندري، لوركا، نيرودا…). لم يكن محمد الصباغ معروفا، وكان المصطلح المتداول آنذاك هو مصطلح النثر الشعري أو الشعر المنثور، وديوانه “شجرة النار” الذي صدر سنة 1954 يمكن أن نعتبره نموذجا أو باكورة لقصيدة النثر التي كتبها محمد الصباغ. عندما كانت مجلة الشعر تقود حركة شعرية في المشرق، كانت هناك قصيدة نثر مغربية تكتب في تطوان والدار البيضاء والرباط وفاس، ومحمد الصبّاغ هو أحد أساتذة هذه القصيدة، وللأسف كان محمد الصباغ في مكان آخر، و”القصيدة التي كان يكتبها لم تأخذ حقها من التأثير.. لم يكن لها تأثير واضح في الحركة الشعرية لا في المغرب ولا في العالم العربي، ولهذا فهذا الرجل ظلّ محتجبا لسبب أو لآخر”.
وتحدّث الوراري عن النّموذج الثاني ضمن قصيدة النثر المغربية، وهو الذي ظهر أواخرَ السبعينات وبداية الثمانينات. وهذا النموذج هو الأوضح، وقد استفاد ليس فقط من قصيدة النثر المشرقية وإنما استفاد أيضا من المنجز الشعري الإسباني والفرنسي على وجه الخصوص: “وهنا أنا أستحضر أسماء مهمّة مثل رشيد المومني وعبد الله زريقة ومحمد بنطلحة وأحمد بركات ومحمد بنيس (الذي كتب قصيدة النثر) وحسن نجمي وإدريس عيسى ومبارك وسّاط ومحمد الشركي وصلاح بوسريف. أعتبر أن هذه الأسماء كتبت قصيدة النثر بمواصفات عالمية، لأنها كانت تحت تأثير نماذج مهمّة من الشّعر الفرنسي والشّعر الذي كان يكتب في المشرق والشعر الإسباني، وهؤلاء الشّعراء للأسف لم يتمّ تسليط الضّوء عليهم. لهذا ظلّ النّتاج الشّعري الذي كتبوه مجهولا إلى حدّ كبير، ليس فقط في المشرق وأيضا حتى في المغرب، بحيث لم تتمّ قراءة متون هؤلاء الشعراء وإضافاتهم على وجه الخصوص.
ولا أريد أن أحدّد أهمّ السّمات أو العناصر الجمالية التي يمكن أن نعثر عليها في هذه النماذج من قصيدة النثر، ولكن أستحضر هنا نموذجا مهمّا للشاعر أحمد بركات.
يقول أحمد بركات في نص “لن أساعد الزلزال”:
“حَذِرٌ، كأني أحمل في كفي الوردة التي توبخ العالم
الأشياء الأكثر فداحة:
قلب شاعر في حاجة قصوى إلى لغة
والأسطح القليلة المتبقّية من خراب البارحة.
حَذِرٌ، أخطو كأني ذاهب على خطّ نزاع
وكأن معي رسائل لجنود
وراية جديدة لمعسكر جديد
بينما الثواني التي تأتي من الوراء تقصف العمر
هكذا..
بكثافة الرماد
معدن الحروب الأولى
تصوغ الثواني صحراءها الحقيقية
وأنا حَذِرٌ، أخطو نحوكم وكأن السحب الأخيرة تحملني
أمطارها الأخيرة
ربما يكون الماء سؤالا حقيقيا
وعليّ أن أجيب بلهجة العطش”.
الحساسيّة الجديدة..
ثم انتقل الوراري بالحديث إلى نقطة موالية متعلّقة بالحساسيّة الجديدة، وقال في هذا الصّدد: “أنتم تعرفون أن هذا المصطلح أثير حقيقةً مع المرحوم إدوار الخراط عندما تناول الظاهرة القصصية، وحاولت أن أنقل هذا المصطلح إلى الظاهرة الشعرية لأني وجدت أن مفهوم الجيل صار مفهوما يضيق عن استيعاب التجارب الشعرية الجديدة. أعني في وقت ما كان هذا المفهوم يستطيع أن يستوعب الأجيال أقول مثلا جيل الخمسينات، جيل الستينات، جيل السبعينات، جيل الثمانينات، لكن بعد ذلك وجدت أن هذا المفهوم صار ملتبسا وصار مفهوما فضفاضا ولا يستطيع أن يستوعب تحته كوكبة من الشعراء تلتقي في بعض السمات الجمالية، كأن أتحدث عن جيل الستينات في المغرب، أو جيل الستينات في العراق، فأنا أضع إلى حدّ كبير العناصر السّمات التي تلتقي عندها هذه الكوكبة من الشعراء. أو عندما أقول مثلا جيل السبعينات في مصر، فأنا أستحضر هذه السمات التي طرحها شعراء مثل حلمي سالم ورفعت سلام وغيرهما إلخ. أو عندما أقول جيل الثمانينات في المغرب، وهو الذي أعطى لقصيدة النثر دفعة قوية، فأنا أركّز على مواصفات نصّيّة خاصة طرحها مع حسن نجمي ومبارك وساط وعبد الله زريقة وغيرهم.
إذن، أقول بأن مفهوم الجيل كان مفهوما منسجما إلى حدّ ما مع هذه الأجيال الستينية والسبعينية والثمانينية، لكن وجدت بدايةً من سنوات التسعينات وإلى اليوم أن هناك شبه استحالة لتطبيق مفهوم الجيل لدراسة النصوص أو لدراسة التجارب الشعرية الجديدة. ولهذا حاولت أن أستغني عن هذا المفهوم بمفهوم آخر هو مفهوم الحساسيّة الجديدة، وعندما أقول حساسيّة جديدة في مقابل حساسية قديمة، لا على مستوى اللغة، أو مستوى الإيقاع، أو مستوى الرؤية الشعرية، ومستوى البناء، ومستوى توظيف الصفحات الشعرية، ومستوى الانتقال من البعد الشفهي إلى البعد الكتابي، ومستوى دخول عناصر جديدة. فمثلا، قبل قليل، طرح الدكتور حاتم الصكر قضية البعد السردي، البعد السيرذاتي، البعد الصوتي…. هذه كانت مطروحة ولكن بنسب محتشمة، الآن صارت ظواهر وبدأت تُطرح بحدة قوية في هذا المجال (متون الحساسية الجديدة).
درست هذا المفهوم من خلال الشعر المغربي الجديد، وأنا أرى أن هذا المفهوم يمكن أن نسحبه على التجارب الشعرية العربية الأخرى، خاصة التجارب الشابة التي ظهرت في الجزائر وفي تونس وفي العراق وفي مصر. في العراق، مثلا، هناك جيل شعري ثائر طرح رؤية شعرية أخرى خاصة مع شعراء ميليشيا الثقافة. وقسْ على ذلك تجارب في الشعر اليماني، والشعر السوداني، والشعر الليبي، ولا أعرف إن كان الأمر كذلك في الشعر الموريتاني.
 عودة إلى الكهوف والمغارات
عودة إلى الكهوف والمغارات
وينوّه الوراري بأن هناك أجيالا جديدة بدأت تطرح تصورات مختلفة للشعر، ويمكن من خلالها أن نتحدث عن أجزاء متفرقة، عن أرخبيلات شعرية ليس بينها أي انسجام، ولا تكتب بسوية واحدة، ولا تكتب تحت تأثير واحد، إنما هناك أمشاج كتابية مختلفة. تجد الهايكو، تجد قصيدة النثر، تجد قصيدة التفعيلة، تجد عودة العمودي، إلخ… فهناك لا أقول فوضى، هناك تنوّع، هناك غنى في المشهد الشعري العربي، وأنا من الناس الذين أحتاط أن أصادر حق الآخرين في التعبير، أو أن أقول إن قصيدة النثر هي النموذج الأسلم والأنسب في التعبير عن اللحظة المعاصرة. لست من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، وأعتبر أن شاعرا يكتب قصيدة النثر مثل شاعر آخر يكتب قصيدة التفعيلة أو قصيدة العمودي إذا كان حقا يمتلك شروط الشعرية لتفجير أسئلة كتابية جديدة.
ولهذا فالحساسية الجديدة لا تنتصر فقط لشكل دون شكل، ولا تنتصر للغة دون لغة، ولا تنتصر لرؤية شعرية دون أخرى، ولكن الذي تلتقي فيه هذه الحساسية الجديدة أنها عزفت عن المعضلات الفكرية والسياسية والأيديولوجية. صار هؤلاء الشعراء يكتبون ذواتهم، يكتبون تجاربهم الشّخصية. صار هناك حضور قويّ للسرديّ. هناك عودة الشّخصي السير ذاتي في هذه النّصوص. هناك أيضا العودة إلى محكيّ الطّفولة الذي يتمّ كتابته بطريقة شعرية مختلفة. هناك حضور لافت للشعر النسائي: بالأمس استمعت إلى شاعرات أكثر مما استمعت إلى شعراء. وحقيقةً المتن الشعري النسائي يطرح اليوم علينا لغة جديدة، رؤية أنثوية. يطرح أيضا تيمة القهر الأنثوي ضمن نصوصه.
مثلما أنّ هناك حضورا لعناصر كثيرة في متون الشعر الجديد: نقد لاذع لمفردات الحضارة المعاصرة الجديدة، المادّية الشّرهة. في المقابل هناك عودة إلى الكهوف والمغارات، عودة إلى الأساطير والأنهار القديمة وكأن الشّعر الجديد ضاق ذرعا بهذه الحضارة المادية المعاصرة. كما نجد عند شعراء آخرين انفتاحا على مادّية الكتابة، وضمن ذلك يتمّ استغلال الصفحة الشعرية وتبئير منحنيات النصّ الشّعري. وحتى النصّ الشّعري لم يعد يكتب بطريقة واحدة. تجد النصّ الكتلة، والنصّ الموزّع إلى أسطر، والنصّ الذي يستغرقه البياض إلخ؛ بمعنى أن هناك إمكانات كتابيّة تطرح بقوة، وتعبر عن روح خلق جديدة. كما أنّ هناك انفتاحا على أسلوب السّرد لبناء المعمار الشّعري، وكتابة أشبه بالهمس عند الشّعراء الذين استبدلوا مفردة كائنة بمفردات أقل ضجيجا وأقل صخبا.. لماذا؟ لأنهم أفلتوا من الزعيق الأيديولوجي والهتاف السياسي، واعتمدوا على قاموس يقترب من الهمس ويحتضن أسلوب الفقرات الشّذريّة بطابعها الذي يقتصد اللغة ويشذّر الإيقاع ويكثّف المعنى داخل النصّ الشعريّ. هناك أيضا بعد آخر وهو قضية البساطة في القول، لم يعد أي من هؤلاء الشّعراء يعتمد على الغموض والتّعقيد اللغويّ، أي اعتماد السّهل الممتنع؛ وهذه نقطة مهمّة تُحسب لهؤلاء الشعراء الجدد، بمعنى أن البسيط هو الأقدر على التأثير الشعري، وهو الأقدر على المباغتة، وعلى الإدهاش وعلى المفارقة.
ويمكن أن نجد لدى شعراء آخرين جماليات العرفان الصّوفي، وهذا أيضا فيه نوع من العزاء الداخلي تجاه هذا العالم وتجاه هذا الذعر المُعَوْلم الذي يكتسح العالم خاصة بعد جائحة كورونا. ونجد عند شعراء آخرين استثمار فنون وتعابير جمالية كثيرة: استثمار لفنون السينما، والتصوير، والرسم، والسيرة الذاتية والرحلة واليوميّات، فصار النصّ الشّعري فسيفساء وأكثر انفتاحا، وخاصة بعد تطويع الشّكل، على هذه الفنون الجمالية.
كما نجد عند شعراء آخرين ارتياد آفاق الحلم والهذيان واللعب باللغة، وهنا أستحضر مثالا على ذلك بعض الشعراء الجميلين في العراق مثل كاظم خنجر، وفي مصر مثل أسامة حداد ومحمد القليني، وفي ليبيا مثل سراج الدين الورفلي، وفي تونس مثل عبد الفتاح بن حمودة وسفيان رجب، كما أستحضر إيمان الخطابي صاحبة الشّذرات المضيئة المفارقة في المغرب.
وفي الحقيقة، فقد استمعت أمس إلى تلك النصوص التي قرأها شواعر وشعراء مختلفون، ولفت انتباهي في نصوصهم حضور هذه الأشياء التي أسردها الآن، ولاسيما انفتاحها على هوامش الجسد، الجسد الذي كان مكبوتا ومعتقلا، ولكن صار الآن يتكلم بمنأى عن الإسفاف الإيروتيكي، وقريبا من الافتتان بالأنثوي الهشّ واللاّنهائي داخل مفردات هذا الجسد. وأخيرا، يمكن أن نقول إن نصوص التجربة (الحساسية) الجديدة، استثمرت الأبعاد الرقميّة؛ فعندما تجد مثلا شاعرا من الشّعراء أو شاعرة من الشّواعر يكتب نصّا أو ينشر نصّا له على صفحات التواصل الاجتماعي، فهو يستثمر هذه الأبعاد الرقمية كأنّ يوظّف لوحة فنية أو مقطعا موسيقيّا، أو يوظّف صورته في وضع من الأوضاع، إلخ. مثل هذه التجربة النوعيّة يجب أن نعطيها ما تستحق من الاهتمام بالنسبة إلى السمات الجمالية التي أصبحت حاضرة بقوة داخل نصوص الحساسية الجديدة.
أجيال الشعر لا أجيال الشعراء..
نقتطف ختاما أهم ما ورد في سياق مداخلات ونقاشات النقاد تعقيبا على ما ذهب إليه الناقد عبد اللطيف الوراري، (ومقتطفات مهمة من إجاباته وردوده) لا سيما ما قال عنه “عدم اهتمام النقاد المشارقة بالقصيدة المغاربية ومفهوم الحساسية الجديدة”:
* حاتم الصكر:
– كثير من الشعراء المغاربة، سواء بنيس أو النجمي، أغلبهم دُرِّسوا وأشعارهم وصلتنا، بل بالعكس أنا أعتب أحيانا أنه النقد الشعري المغربي لم يسلط الضّوء (على الشعراء المشارقة).
– النقد الشعري في المغرب العربي محتاج إلى أن يهتمّ بالأصوات المغربية نفسها مثل الصباغ وصار عندي فضول لقراءته لكن كيف سأجد من يرشدني لأقرأ له. والأسماء التي ذكرها الوراري أيضا، تحتاج إلى أن يسلط الضوء عليها.
– مسألة الحساسيّة الجديدة: أنا مع الصديق دكتور الوراري. هذا يحلّ مشكلة الجيل فعلا، وإن كنا اليوم نطرح فكرة أن الحديث يجب أن يتمّ عن أجيال الشعر وليس عن أجيال الشّعراء، بهذا المعنى نستطيع أن نتحدث عن شاعر تونسي ومغربي وعراقي ويمني وسوري ومصري إلخ… لكن في ضوء الجينات الموجودة في الشعر نفسه، في القصيدة وليس في الشاعر، ولهذا هناك شعراء يعزّون على التصنيف.
– ثنائية المشرق والمغرب أمر موجود حتى في التراث الخلدوني، لكن في المقابل أيضا هناك نزعة إقصائية للأسف، ولو أنها خفّت الآن، أنا أتكلم عن جيل بنيس، وأعترف أن هناك تقصيرا سببه نسف الجسور الممكنة بين المشرق والمغرب، فاليوم لم يعد بالإمكان الحصول على الكتاب والمجلة المغربية مثلما كنا في جيلنا، وبالمناسبة، هذا الإقصاء يحسّه حتى شعراء من الجزيرة العربية.
* عبد اللطيف الوراري:
– الشعرية العراقية شعرية مهمّة، وقد درست مؤخرا السياب ونازك في مقالات صحافية متفرقة.
– بنعيسى بوحمالة أنجز كتابا مهمّا عن جيل الستينات العراقي واستشهد بحسب الشيخ جعفر.
– النقد المغربي درس كثيراً من النماذج العراقية، درس سركون بولص، صلاح فائق والسياب والبياتي.
– هناك مئات الأطروحات كُتِبت عن الشعر العراقي لأنه كان شعرا رياديا، كان شعرا مؤسسا، يجب ألّا نصادر هذه الحقيقة، لأن أرض العراق هي التي أنتجت هذه الشعرية الجديدة التي نتفيّأ الآن ظلالها.
– بدأ الآن نوع من رأب الصدع بين الضفتين، للتقريب بين الشعرية المغاربية والشعرية المشرقية.
الحساسية الجديدة بوصفها ظاهرةً..
* وجدان الصائغ (متسائلة): الحساسية الجديدة على أي أساس هي قائمة؟ وأنت تتبنى مصطلح الحساسية الجديدة مقابل الجيل.. هناك شعراء صعب جدا أن تضعهم في خانة معينة؟
* عبد اللطيف الوراري:
– كتابي “راهن الشعر المغربي.. من الجيل إلى الحساسية”، ناقشت فيه مسألة مفهوم الحساسية: مجموعة كبيرة من السّمات الجمالية وجدتها كثيرة جدا، هناك بعض السمات كانت مطروحة في الشعر السابق الثمانيني والسبعيني والستيني ولكن كانت مطروحة بشكل محتشم أو كانت مطروحة بشكل أقلّ، لكن أبعاد الحساسية الجديدة طرحت بقوة، يعني صارت ظاهرة.
– عندما أستحضر اسما شعريا مغربيا: محمد السرغيني هذا شاعر مهمّ. يمكن للشاعر أن تتطور قصيدته عبر أجيال مختلفة. السرغيني كما كتب في الخمسينات والسبعينات ليس السرغيني الذي كتب نصوصه قبل خمس أو ستّ سنوات، مختلفة تماما، شاعر قوي، شاعر مدهش. كان يتجدد من جيل إلى آخر. السّرغيني يحمل جينات الشّعر وتجد في شعره هذه الحساسيّة التي تجلّت أو التي تشكل ذاتها. كثير من النقاد يتعرضون لقراءة شعر السرغيني، شعر ملتبس، شعر غامض، ولكنه شعر يحتاج إلى ناقد حقيقي.
– الحساسية هي مفهوم مركّب فوق متشعّب، مفهوم يمكن أن يأخذ أبعادا كثيرة، ولكنه على الأقل يعطينا إمكانات كبيرة إجرائية وتحليلية ونقدية لدراسة المشهد الشعري الجديد.
– مفهوم الحساسية أتخذه بديلا عن مفهوم الجيل الذي تضيق عليه النصوص الشعرية، لا على مستوى اللغة، لا على مستوى الإيقاع، ولا على مستوى الرؤية الشعرية.
* وجدان الصائغ (متسائلة):
– نسمع باستمرار أن هناك مشكلة في النقد ونحن ندافع عن حضور النقد، أنت تقول “تفجر شعريّ مقابل نكوص نقدي”.
* عبد اللطيف الوراري:
– في العقود الأخيرة، عندما أقول مثلا في الخمسينات والستينات والسبعينات، كان نقد الشعر هو النقد الذي يقود حركة التجديد الثقافي العربي، عندما أستحضر أسماء كثيرة مثل جبرا ابراهيم جبرا، رجاء النقاش، عز الدين اسماعيل، حاتم الصكر، وأستحضر مثلا يوسف سامي اليوسف، هؤلاء النقاد ساهموا في تحديث الثقافة العربية من خلال الشعر.
– نقد الشعر كان دائما يقدم لنا إضاءات مهمة، يقدم لنا أسئلة، يقدم لنا خبرات جمالية إلخ…
– اليوم نقد تراجع الشعر كثيرا. أخلى مكانه لنقد الرواية ونقد المسرحية، وغيرهما.
* وجدان الصائغ:
– أشعر أنه ما خرج الناقد العربي من جبّة المعلّم، لذلك هذا النكوص.
– كثير من الأصوات، تحديدا الأصوات النسائية تحتاج إلى الكثير من الدفع النفسي.
– يفتقد النقد العربي أولا فكرةَ النظرية، يعني باستمرار الذي يكتب يتكبر عن أن يذكر السابق في هذا النقد ولكن أيضا النقد العربي يحتاج إلى أن يأخذ أو ينتشل الصوت الإبداعي الحقيقي من زاوية إلى زاوية أخرى.
– بعض النصوص الإبداعية أو النصوص الشعرية خاضعة لأجندة إعلامية لذلك تجدها منزوية.
– النقد الأدبي المغربي وصلني قبل الشعر والابداع المغربي، أتذكر على سبيل المثال سعيد يقطين وشعيب حليفي وزهور كرّام، لكن هذا النقد يحمل باستمرار عصا المعلم المتشدّد.
* حاتم الصكر:
– هناك انشغال بالنظرية. إغراق فيها دون ممارسة.
– ثمّة كتاب استشهدت به في أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، الذي هو “موت الناقد” الذي ترجمه صديقنا فخري صالح، يشكو مؤلفه (البريطاني) أن النقد الشعري لم يعد كما هو، اختلط، رفض القيمة ورفض المعيار، أنا مع الدكتورة وجدان، يعني ما راح نقيم ونقول له: نعم بخ بخ فأنت شاعر ولا نقول له روح أنت مطرود من جنة الشعراء، لا، هذه أحكام قيمة تجاوزناها الآن، نحن نشتغل الآن في مناطق أكثر تطورا منه… لكن في المقابل صار هناك تشويش على الخطاب النقدي: (اسمحوا لي أن أقول ويمكن يخالفني البعض الرأي) النقد الثقافي الذي وصلنا على طريقة الميتات، لا أدري لماذا يُعجَب الناس بالميتات، موت المؤلف وموت الشعر لصالح الرواية والآن موت الناقد، موت النقد الأدبي عفوا؟! الدكتور الغذامي أنهى كتابه وبدأه على النقد الثقافي بالقول: آن للنقد الأدبي أن يموت وممكن أن يأتي غيره في النقد الثقافي، بدأ يتحدث مثلا عن أفيشة الفيلم التي تعلق على الفيلم وليس عن الفيلم.
– جرّ النقد الأدبي إلى هذه المسالك أفقده (أدبيّته)، وهذا واحد من العوامل التي تساهم في العزلة.
– وسائط التوصيل الاتصالية اليوم بدأت تضخّ أنواعا من النقد: القراءات السريعة، وبالتالي لم يعد القرّاء مهتمّين برأي ناقد يقرأ هذا الكتاب الشعري ويحلله ويقتفي أبعاده وصلته بغيره وتجاوزه للحركة الشعرية القائمة والجديد فيه. هذه العوامل شُوِّهت وعزلت النقد الشعري وعطّلته.
– المعضلة الأكبر هي التشويش الذي يحدث للنقد الشعري من هذه الهبّات، ليأخذ مكان الناقد شخص غير مؤهل للقراءة وإنما هو (مثلما قالت دكتورة وجدان) إعلامي في الغالب، أو قراءته قراءة سريعة بحكم الوسيط الذي يتعامل معه.
* عبد اللطيف الوراري:
– هناك حركة شعريّة قوية في المشرق والمغرب، لكن داخل هذه الحركة هناك آلاف الشعراء والشواعر لا علاقة لهم بالشعر.
– كناقد أو كمهتمّ، الذي يعنيني هو أن أجد القيم المضافة لهذا الشعر أو ذاك.
– ما يعنيني هو النصوص المضيئة المدهشة، أين أضعها داخل حركة الشعر اليوم؟ وعليّ أن ألتقط هذه الأصوات التي تستحقّ منّا الاهتمام.
– كثير من الأصوات المهمّة الآن لا يُلقى عليها الضّوء: هناك شعراء مكرّسون صاروا لا يكتبون الشّعر، صارت لديهم فقط الشرعية الثورية والشرعية التاريخية، لكنهم من الحركة الشعرية. في المقابل هناك شعراء شباب يضيئون ويضيفون إلى هذه الحركة، ويجب أن ألقي الضّوء على شعرهم.
* أحمد الفلاحي:
– يبدو أن الحساسية مشكلة أزلية لدى الناس جميعا وفي الوسط الأدبي خاصة، فقد حاولنا جاهدين في مجلة نصوص من خارج اللغة أن نردم الهوة ونضع حدا لهذه الحساسية ولذلك قدمنا ملفّا عن الشّعر المغربيّ وعن الشّعر في بلدان عربية وعالمية عدة. مسألة الحساسيّة الأدبية بشكل عامّ، الجانب السّياسي له الدّور الكبير في فتح فجوتها، ما بين المشرق والمغرب حتى صارت حركة خفيّة ومفرطة وثمة إثنيات وقوميات لها دور كبير في هذا الموضوع.
– العالم في ظل العولمة والتقانة والتقدم كان يجب أن يزيح هذه الحساسية جانبا في ظل العالم المفتوح (القرية الواحدة) لكن على العكس، يتقوقع النّاس في حويصلات صغيرة بدلا عن الانفتاح على الآخر.
نشير ختامًا، إلى أنه تمّ نشر مادة تغطية لفعاليات هذه الندوة الإلكترونية بمنبر “ضفة ثالثة” الثقافي بتاريخ 2 سبتمبر 2020 بعنوان هذه المادة نفسها، إلا أن آلية النشر بالموقع اقتضت أن تنشر تغطية في حدود 2000 كلمة، وهنا حاولنا نشر التغطية بشيء من التوسّع والتفصيل، لتعميم الفائدة للقارئ العربي والمهتمّين بدراسة وتحليل منجز قصيدة النثر العربية.




